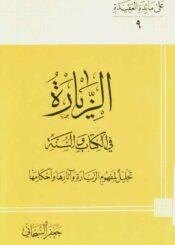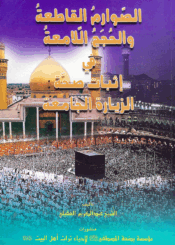معنى الدعاء
معنى الدعاء
0 Vote
213 View
إن قوله تعالى : ( وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ) البقرة : 186 . أحسن بيان لما اشتمل عليه من المضمون ، وأرقُّ أسلوب وأجمله ، فقد وضع أساسه على التكلم وحده دون الغيبة ونحوها ، وفيه دلالة على كمال العناية بالأمر . وقال تعالى : ( عِبَادِي ) ، ولم يقل : الناس وما أشبهه ، ليزيد في هذه العناية ، ثم حذف الواسطة في الجواب ، حيث قال : ( قَرِيبٌ أُجِيبُ ) ولم يقل : فقل : إنه قريب ، ثم التأكيد بـ( إِنَّ ) . ثم الإتيان بالصفة دون الفعل الدال على القرب ليدل على ثبوت القرب ودوامه ، ثم الدلالة على تجدد الإجابة واستمرارها ، حيث أتى بالفعل المضارع الدال عليهما . ثم تقييده الجواب ، أي قوله : ( أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ ) بقوله : ( إِذَا دَعَانِ ) ، وهذا القيد لا يزيد على قوله : ( دَعْوَةَ الدَّاعِ ) المقيد به شيئاً بل هو عينه ، وفيه دلالة على أن دعوة الداع مُجابة من غير شرط وقيد ، كقوله تعالى : ( ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ) غافر : 60 . فهذه سبع نكات في الآية تنبئ بالاهتمام في أمر استجابة الدعاء والعناية بها ، مع كون الآية قد كرر فيها - على إيجازها - ضمير المتكلم سبع مرات ، وهي الآية الوحيدة في القرآن على هذا الوصف . والدعاء والدعوة توجيه نظر المدعو نحو الداعي ، والسؤال جلب فائدة أو در من المسؤول يرفع به حاجة السائل بعد توجيه نظره ، فالسؤال بمنزلة الغاية من الدعاء ، وهو المعنى الجامع لجميع موارد السؤال كالسؤال لرفع الجهل والسؤال بمعنى الحساب والسؤال بمعنى الاستدرار وغيره . ثم إن العبودية كما مر سابقاً هي المملوكية ، ولا كل مملوكية بل مملوكية الإنسان ، فالعبد هو من الإنسان أو كل ذي عقل وشعور ، كما في الملك المنسوب إليه تعالى . وملكه تعالى يغاير ملك غيره مغايرة الجد مع الدعوى ، والحقيقة مع المجاز ، فإنه تعالى يملك عباده ملكاً مطلقاً ، محيطاً بهم ، لا يستقلون دونه في أنفسهم ولا ما يتبع أنفسهم من الصفات والأفعال ، وساير ما ينسب إليهم من الأزواج والأولاد والمال والجاه وغيرها . فكل ما يملكونه من جهة إضافته إليهم بنحو من الأنحاء كما في قولنا : نفسه ، وبدنه ، وسمعه ، وبصره ، وفعله ، وأثره ، وهي أقسام الملك بالطبع والحقيقة . وقولنا : زوجه وماله وجاهه وحقه - وهي أقسام الملك بالوضع والاعتبار - إنما يملكونه بإذنه تعالى ، في استقرار النسبة بينهم وبين ما يملكون . فالله عزَّ اسمه هو الذي أضاف نفوسهم وأعيانهم إليهم ، ولو لم يشاء لم يضف ، فلم يكونوا من رأس ، وهو الذي جعل لهم السمع والأبصار والأفئدة ، وهو الذي خلق كل شيء وقدَّره تقديراً . فهو سبحانه الحائل بين الشيء ونفسه ، وهو الحائل بين الشيء وبين كل ما يقارنه من ولد ، أو زوج ، أو صديق ، أو مال ، أو جاه ، أو حق ، فهو أقرب إلى خلقه من كل شيء مفروض ، فهو سبحانه قريب على الإطلاق كما قال تعالى : ( وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لاَّ تُبْصِرُونَ ) الواقعة : 85 . وقال تعالى : ( وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ) ق : 16 . وقال تعالى : ( أَنَّ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ) الأنفال : 24 ، والقلب هو النفس المدركة . وبالجملة فملكه سبحانه لعباده ملكاً حقيقياً ، وكونهم عباداً له هو الموجب لكونه تعالى قريباً منهم على الإطلاق ، وأقرب إليهم من كل شيء عند القياس . وهذا الملك الموجب لجواز كل تصرف شاء كيفما شاء من غير دافع ولا مانع يقضي أن لله سبحانه أن يجيب أي دعاء دعى به أحد من خلقه ، ويرفع بالإعطاء والتصرف حاجته التي سأله فيها ، فإن الملك عام ، والسلطان والإحاطة واقعتان على جميع التقادير ، من غير تقيد بتقدير دون تقدير ، لا كما يقوله اليهود : إن الله لما خلق الأشياء وقدَّر التقادير تمَّ الأمر ، وخرج زمام التصرف الجديد من يده بما حتمه من القضاء . فلا نسخ ولا بداء ولا استجابة لدعاء لأن الأمر مفروغ عنه ، ولا كما يقوله جماعة من هذه الأمة : أن لا صنع لله في أفعال عباده وهم القدرية الذين سمَّاهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مجوس هذه الأمة ، فيما رواه الفريقان من قوله ( صلى الله عليه وآله ) : ( القدريَّة مَجُوسُ هَذِهِ الأمَّةِ ) . بل الملك لله سبحانه على الإطلاق ، ولا يملك شيء شيئاً إلا بتمليكٍ منه سبحانه وإذن ، فما شاء وملك وأذِن في وقوعه يقع ، وما لم يشأ ولم يملك ولم يأذن فيه لا يقع ، وإن بُذِل في طريق وقوعه كل جهد وعناية . فقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاء إِلَى اللهِ وَاللهُ هُوَ الْغَنِيُّ ) فاطر - 15 . فقد تبين أن قوله تعالى : ( وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ) البقرة : 186 ، كما يشتمل على الحكم - أي إجابة الدعاء - كذلك يشتمل على عِلَلِهِ . فكون الداعين عباداً لله تعالى هو الموجب لقُربِه منهم ، وقربه منهم هو الموجب لإجابته المطلقة لدعائهم ، وإطلاق الإجابة يستلزم إطلاق الدعاء ، فكل دعاء دعي به فإنه مجيبه . إلا أن هاهنا أمرا وهو أنه تعالى قيد قوله : ( أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ) ، وهذا القيد غير الزائد على نفس المقيد بشيء يدل على اشتراط الحقيقة دون التجوز والشبه . فإن قولنا : اِصغِ إلى قول الناصح إذا نصحك ، أو أكرم العالم إذا كان عالماً ، يدل على لزوم اتِّصافه بما يقتضيه حقيقة ، فالناصح إذا قصد النصح بقوله فهو الذي يجب الإصغاء إلى قوله ، والعالم إذا تحقَّق بعلمه وعمل بما علم كان هو الذي يجب إكرامه . فقوله تعالى : ( إِذَا دَعَانِ ) ، يدل على أن وعد الإجابة المطلقة إنما هو إذا كان الداعي داعياً بحسب الحقيقة ، مريداً بحسب العلم الفطري والغريزي ، مواطئاً لسانه قلبه . فإن حقيقة الدعاء والسؤال هو الذي يحمله القلب ويدعو به لسان الفطرة ، دون ما يأتي به اللِّسان الذي يدور كيفما أدير ، صدقاً أو كذباً ، جِدّاً أو هزلاً ، حقيقةً أو مجازاً ، ولذلك ترى أنه تعالى عَدَّ ما لا عمل للسان فيه سؤالاً . قال تعالى : ( وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ) إبراهيم : 34 . فهم فيما لا يحصونها من النعم داعون سائلون ولم يسألوها بلسانهم الظاهر ، بل بلسان فقرهم واستحقاقهم لساناً فطريّاً وجودياً . وقال تعالى : ( يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ) الرحمن : 29 ، ودلالته على ما ذكرنا أظهر وأوضح . فالسؤال الفطري من الله سبحانه لا يتخطى الإجابة ، فما لا يستجاب من الدعاء ولا يصادف الإجابة فقدْ فقدَ أحد أمرين ، وهما اللذان ذكرهما بقوله : ( دَعْوَةَ الْدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ) . فإما أن يكون لم يتحقق هناك دعاء ، وإنما التبس الأمر على الداعي التباساً كان يدعو الإنسان فيسأل ما لا يكون وهو جاهل بذلك ، أو ما لا يريده لو انكشف عليه حقيقة الأمر . مثل أن يدعو ويسأل شفاء المريض لا إحياء الميت ، ولو كان استمكنه ودعا بحياته كما كان يسأله الأنبياء لأعيدت حياته ، ولكنه على يأس من ذلك ، أو يسأل ما لو علم بحقيقته لم يسأله فلا يُستجاب له فيه . وإما أن السؤال متحقق لكن لا من الله وحده كمن يسأل الله حاجة من حوائجه وقلبه متعلق بالأسباب العادية أو بأمور وهمية توهمها كافية في أمره أو مؤثرة في شأنه ، فلم يخلص الدعاء لله سبحانه ، فلم يسأل الله بالحقيقة ، فإن الله الذي يجيب الدعوات هو الذي لا شريك له في أمره ، لا من يعمل بشركة الأسباب والأوهام ، فهاتان الطائفتان من الدعاة السائلين لم يخلصوا الدعاء بالقلب وإن أخلصوه بلسانهم . فهذا ملخص القول في الدعاء على ما تفيده الآية ، وبه يظهر معاني سائر الآيات النازلة في هذا الباب كقوله تعالى : ( قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ ) الفرقان : 77 . وقوله تعالى : ( قُلْ أَرَأَيْتُكُم إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ * بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاء وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ) الأنعام : 40 - 41 . وقوله تعالى : ( قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً لَّئِنْ أَنجَانَا مِنْ هَـذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ * قُلِ اللّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ) الأنعام : 63 - 64 . فالآيات دالة على أن للإنسان دعاء غريزياً وسؤالاً فطرياً يسأل به ربه ، غير أنه إذا كان في رخاء ورفاه تعلقت نفسه بالأسباب فأشركها لربه ، فالتبس عليه الأمر وزعم أنه لا يدعو ربه ولا يسأل عنه ، مع أنه لا يسأل غيره ، فإنه على الفطرة ، ولا تبديل لخلق الله تعالى . ولما وقع الشدة وطارت الأسباب عن تأثيرها ، وفقدت الشركاء والشفعاء ، تبين له أن لا منجح لحاجته ، ولا مجيب لمسألته إلا الله ، فعاد إلى توحيده الفطري ونسي كل سبب من الأسباب ، ووجه وجهه نحو الرب الكريم ، فكشف شدَّته ، وقضى حاجته ، وأظله بالرخاء ، ثم إذا تلبس به ثانياً عاد إلى ما كان عليه أولاً من الشرك والنسيان . وكقوله تعالى : ( وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ) غافر : 60 . والآية تدعو إلى الدعاء وتعد بالإجابة وتزيد على ذلك حيث تسمي الدعاء عبادة بقولها : ( عَنْ عِبَادَتِي ) ، أي : عن دعائي . بل تجعل مطلق العبادة دعاء حيث أنها تشتمل الوعيد على ترك الدعاء بالنار والوعيد بالنار إنما هو على ترك العبادة رأساً لا على ترك بعض أقسامه دون بعض ، فأصل العبادة دعاء ، فافهم ذلك . وبذلك يظهر معنى آيات آخر من هذا الباب كقوله تعالى : ( فَادْعُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ) غافر : 14 . وقوله تعالى : ( وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ) الأعراف : 56 . وقوله تعالى : ( وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ) الأنبياء : 90 . وقوله تعالى : ( ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ) الأعراف : 55 . وقوله تعالى : ( إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاء خَفِيًّا ) مريم : 3 ، إلى قوله : ( وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ) مريم : 4 . وقوله تعالى : ( وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ ) الشورى : 26 . إلى غير ذلك من الآيات المناسبة ، وهي تشتمل على أركان الدعاء وآداب الداعي ، وعمدتها الإخلاص في دعائه تعالى وهو مواطات القلب اللسان والانقطاع عن كل سبب دون الله والتعلق به تعالى . ويلحق به الخوف ، والطمع ، والرغبة ، والرهبة ، والخشوع ، والتضرع ، والإصرار ، والذكر ، وصالح العمل ، والإيمان ، وأدب الحضور ، وغير ذلك مما تشتمل عليه الروايات . وقوله تعالى : ( فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي ) البقرة : 186 ، تفريع على ما يدل عليه الجملة السابقة عليه بالالتزام : أن الله تعالى قريب من عباده ، لا يحول بينه وبين دعائهم شيء ، وهو ذو عناية بهم وبما يسألونه منه . فهو يدعوهم إلى دعائه ، وصفته هذه الصفة ، فليستجيبوا له في هذه الدعوة ، وليقبلوا إليه ، وليؤمنوا به في هذا النعت ، وليوقنوا بأنه قريب مجيب لعلهم يرشدون في دعائه . بحث روائي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) وسلم فيما رواه الفريقان : ( الدُّعَاءُ سِلاحُ المُؤمِن ) . وفي عدة الداعي في الحديث القدسي : ( يَا مُوسَى سَلْنِي كُلّ مَا تَحْتَاج إِلَيه حَتَّى عَلَف شَاتِك ومِلْح عَجِينِكَ ) . وفي المكارم عنه ( عليه السلام ) : ( الدُّعَاءُ أفضَلُ من قِراءَةِ القُرآنِ ، لأنَّ اللهَ عَزَّ وجَلَّ قال : ( قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ ) الفرقان : 77 . وروي ذلك عن الإمامين الباقر والصادق ( عليهما السلام ) . وفي عدة الداعي في رواية محمد بن عجلان عن محمد بن عبيد الله بن علي بن الحسين عن ابن عمه الصادق عن آبائه ( عليهم السلام ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : ( أوْحَى اللهُ إلَى بِعْضِ أنْبِيَائِهِ فِي بَعضِ وَحْيِهِ : وَعِزَّتِي وَجَلالِي لأقْطَعَنَّ أمَلَ كُلِّ آمِلٍ أملَ غَيرِي بالأياس ، ولأكْسُوَنَّهُ ثَوبَ المَذلَّةِ فِي النَّاسِ ، ولأبْعِدنَّه من فَرَجِي وَفَضْلِي ، أيَأمَلُ عَبدِي فِي الشَّدَائِدِ غَيرِي والشَّدَائِدُ بِيَدِي ، ويَرجُو سِوايَ وَأنَا الغَنِي الجَوَاد ، بِيَدِي مَفَاتِيحَ الأبْوَابِ وَهي مُغلَقَة ، وبَابِي مَفتُوحٌ لِمَنْ دَعَانِي ) . وفي عدة الداعي أيضاً عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : ( قَالَ اللهُ : مَا مِنْ مَخلُوقٍ يَعْتَصِمُ بِمَخلُوقٍ دُوني إلاَّ قَطَعْتُ أسْبَابَ السَّمَاوَاتِ وأسْبَابَ الأرْضِ مِنْ دُونِه ، فَإنْ سَألَنِي لَمْ أعْطِهِ ، وإنْ دَعَانِي لَمْ أجِبْهُ ، ومَا مِنْ مَخلوقٍ يَعْتَصِمُ بِي دُونَ خَلقِي إلاَّ ضمنَتْ السَّمَاوَاتُ والأرْضُ رِزقَهُ ، فَإنْ دَعَانِي أجَبتُه ، وإنْ سَألَني أعْطَيتُه ، وإنْ اسْتَغْفَرَنِي غَفرتُ لَه ) . أقول : وما اشتمل عليه الحديثان هو الإخلاص في الدعاء وليس إبطالاً لسببية الأسباب الوجودية التي جعلها الله تعالى وسائل متوسطة بين الأشياء وبين حوائجها الوجودية ، لا عِللاً فيَّاضة مستقلة دون الله سبحانه . وللإنسان شعور باطني بذلك ، فإنه يشعر بفطرته أن لِحَاجته سبباً معطياً لا يتخلَّف عنه فعله ، ويشعر أيضاً أنَّ كل ما يتوجه إليه من الأسباب الظاهرية يمكن أن يتخلف عنه أثره . فهو يشعر بأن المبدأ الذي يبتدئ عنه كل أمر ، والركن الذي يعتمد عليه ويركن إليه كل حاجة في تحققها ووجودها غير هذه الأسباب . ولازم ذلك أن لا يركن الركون التام إلى شيء من هذه الأسباب ، بحيث ينقطع عن السبب الحقيقي ويعتصم بذلك السبب الظاهري . والإنسان ينتقل إلى هذه الحقيقة بأدنى توجه والتفات ، فإذا سئل أو طلب شيئاً من حوائجه فوقع ما طلبه كَشَف ذلك أنه سئل ربه واتَّصَل حاجته التي شعر بها بشعوره الباطني من طريق الأسباب إلى ربه فاستفاض منه . وإذا طلب ذلك من سبب من الأسباب فليس ذلك من شعور فطري باطني ، وإنما هو أمر صوَّره له تخيله لِعِلَل أوجَبَتْ هذا التخيل من غير شعور باطني بالحاجة ، وهذا من الموارد التي يخالف فيها الباطن الظاهر . ونظير ذلك : أن الإنسان كثيراً ما يُحب شيئاً ويهتمّ به حتى إذا وقع وجده ضاراً بما هو أنفع منه ، وأهم وأحب ، فترك الأول وأخذ بالثاني . وربَّما هرب من شيء حتى إذا صادفه وجده أنفع وخيراً مما كان يتحفظ به ، فأخذ الأول وترك الثاني . فالصبي المريض إذا عرض عليه الدواء المر امتنع من شربه وأخذ بالبكاء وهو يريد الصحة ، فهو بشعوره الباطني الفطري يسأل الصحة ، فيسأل الدواء وإن كان بلسان قوله أو فعله يسأل خلافه . فللإنسان في حياته نظام بحسب الفهم الفطري والشعور الباطني ، وله نظام آخر بحسب تخيله والنظام الفطري لا يقع فيه خطاء ولا في سيره خَبْط ، وأما النظام التخيّلي فكثيراً ما يقع فيه الخطاء والسهو . فربما سأل الإنسان أو طلب بحسب الصورة الخيالية شيئاً ، وهو بهذا السؤال بعينه يسأل شيئاً آخر أو خلافه ، فعلى هذا ينبغي أن يقرر معنى الأحاديث ، وهو اللائح من قول الإمام علي ( عليه السلام ) فيما سيأتي : ( إِنَّ العَطيَّةَ عَلَى قَدَرِ النِّيَّة ) . وفي عدة الداعي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( ادْعُوا اللهَ وَأنْتُم مُوقِنُونَ بِالإجَابَةِ ) . وفي الحديث القدسي : ( أنَا عِنْد ظَنّ عَبْدِي بِي ، فَلا يَظُن بِي إلاَّ خَيراً ) . أقول : وذلك أن الدعاء مع اليأس أو التردد يكشف عن عدم السؤال في الحقيقة كما مر ، وقد ورد المنع عن الدعاء بما لا يكون . وفي العدة أيضاً عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( افْزَعُوا إلَى اللهِ فِي حَوائِجِكُم ، والْجَئوا إليهِ فِي مُلِمَّاتِكُم ، وتَضرَّعُوا إِلَيهِ وادْعُوه ، فَإنَّ الدُّعَاءَ مُخّ العِبَادَة ، ومَا مِنْ مُؤمِنٍ يَدعُو اللهَ إلاَّ استُجَابَ ، فَإمَّا أنْ يُعجِّلُهُ لَهُ فِي الدّنيَا أوْ يُؤجِّل لَهُ فِي الآخِرَة ، وإمَّا أنْ يُكَفِّر لَهُ مِن ذُنُوبِه بِقَدر مَا دَعَا مَا لَمْ يَدْعُ بِمَأثم ) . وفي نهج البلاغة في وصية للإمام ( عليه السلام ) لابنه الحسين ( عليه السلام ) : ( ثُمَّ جَعَلَ في يَدَيكَ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِه بِمَا أذِنَ لَكَ فِيهِ مِنْ مَسْألَتِه ، فَمَتَى شِئْتَ اسْتَفتَحْتَ بالدُّعَاءِ أبْوَابَ نِعَمِهِ ، وَاسْتَمْطَرْتَ شَئَابِيبَ رَحْمَتِهِ ، فَلا يُقْنِطَنَّكَ إِبْطَاءُ إجَابَتِه ، فَإنَّ العَطِيَّة عَلَى قَدر النيَّة . وَرُبَّمَا أخِّرَتْ عَنكَ الإجَابَة لِيَكُونَ ذَلِكَ أعْظَمُ لأجْرِ السَّائِلِ ، وأجْزَلُ لِعَطَاءِ الآمل ، وَربَّمَا سَألْتَ الشَّيء فَلا تُؤتَاهُ وأوتِيتَ خَيراً مِنهُ عَاجِلاً أو آجِلاً ، أو صُرِفَ عَنْكَ لِمَا هُوَ خَيرٌ لَكَ . فَلَرُبَّ أمْرٍ قَدْ طَلبتَهُ فِيهِ هَلاكُ دِينِكَ لَو أوتِيْتَه ، فَلْتَكُنْ مَسْألَتُكَ فِيمَا يَبقَى لَكَ جَمَالُه ، ويَنْفي عَنكَ وَبَالُه ، وَالمَالُ لا يَبقَى لَكَ وَلا تَبقَ لَهُ ) . أقول : قوله ( عليه السلام ) : ( فَإنَّ العَطِيَّة عَلَى قَدر النيَّة ) ، يريد به : أنَّ الاستجابة تطابق الدعوة ، فما سأله السائل منه تعالى على حسب ما عقد عليه حقيقة ضميره ، وحمله ظهر قلبه ، هو الذي يؤتاه ، لا ما كشف عنه قوله وأظهره لفظه . فإن اللفظ ربما لا يطابق المعنى المطلوب كل المطابقة كما مرَّ بيانه ، فهي أحسن جملة وأجمع كلمة لبيان الارتباط بين المسألة والإجابة . وقد بيَّن ( عليه السلام ) بها عدَّة من الموارد التي يتراءى فيها تخلف الاستجابة عن الدعوة ظاهراً ، كالإبطاء في الإجابة ، وتبديل المسؤول عنه في الدنيا بما هو خير منه في الدنيا ، أو بما هو خير منه في الآخرة ، أو صرفه إلى شيء آخر أصلح منه بحال السائل . فإن السائل ربما يسأل النعمة الهنيئة ، ولو أوتيها على الفور لم تكن هنيئة وعلى الرغبة ، فتبطئ إجابتها لأن السائل سأل النعمة الهنيئة . فقد سأل الإجابة على بطؤ ، وكذلك المؤمن المهتم بأمر دينه لو سأل ما فيه هلاك دينه وهو لا يعلم بذلك ، ويزعم أن فيه سعادته وإنما سعادته في آخرته ، فقد سأل في الحقيقة لآخرته لا دنياه ، فيُستَجاب لذلك فيها لا في الدنيا . وفي عدة الداعي عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : ( مَا بَسَطَ عَبدٌ يَدُه إلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ إلاَّ اسْتَحْيَى اللهُ أنْ يَرُدَّهَا صِفراً حتى يَجْعَلَ فِيهَا مِنْ فَضْلِهِ وَرَحْمَتِه مَا يَشَاءُ ، فَإذَا دَعَا أحَدُكُم فَلا يَرُدّ يَدَه حَتَّى يَمْسَحُ بِهَا عَلَى رَأسِه وَوَجْهِه ) . وفي خبر آخر : ( عَلَى وَجْهِهِ وَصَدْرِهِ ) . أقول : وقد روي في الدر المنثور ما يقرب من هذا المعنى عن عدة من الصحابة كسلمان ، وجابر ، وعبد الله بن عمر ، وأنس بن مالك ، وابن أبي مغيث ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في ثماني روايات ، وفي جميعها رفع اليدين في الدعاء ، فلا معنى لإنكار بعضهم رفع اليدين بالدعاء معلِّلاً بأنه من التجسيم . إذ رفع اليدين إلى السماء إيماء إلى أنه تعالى فيها ، تعالى عن ذلك وتقدَّس ، وهو قول فاسد . فإن حقيقة جميع العبادات البدنية هي تنزيل المعنى القلبي والتوجه الباطني إلى موطن الصورة ، وإظهار الحقائق المتعالية عن المادة في قالب التجسم ، كما هو ظاهر في الصلاة والصوم والحج وغير ذلك ، وأجزائها وشرائطها ، ولو لا ذلك لم يستقم أمر العبادة البدنية . ومنها الدعاء ، وهو تمثيل التوجه القلبي والمسألة الباطنية بمثل السؤال الذي نعهده فيما بيننا من سؤال الفقير المسكين الداني من الغني المتعزز العالي حيث يرفع يديه بالبسط ، ويسأل حاجته بالذلة والضراعة . وقد روى الشيخ في المجالس والأخبار مسنداً عن محمد وزيد ابني علي بن الحسين عن أبيهما عن جدِّهما الحسين ( عليه السلام ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) . وفي عدَّة الداعي مرسلاً أنَّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يرفع يديه إذا ابتهل ودعا كما يستطعم المسكين . وفي البحار عن الإمام علي ( عليه السلام ) أنه سمع رجلاً يقول : اللهم إني أعوذ بك من الفتنة . فقال ( عليه السلام ) : ( أرَاكَ تَتَعوَّذُ مِن مَالِكَ وَولدِكَ ) . يقول الله تعالى : ( إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ) التغابن : 15 . ولكن قل : ( اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بِكَ مِنْ مُضِلاَّتِ الفِتَنِ ) . أقول : وهذا باب آخر في تشخيص معنى اللَّفظِ ، وله نظائر في الروايات ، وفيها : أن الحق في معنى كل لفظ هو الذي ورد منه في كلامه ، ومن هذا الباب ما ورد في الروايات في تفسير معنى الجزء والكثير وغير ذلك . وفي عدة الداعي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : ( إِنَّ اللهَ لا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً بِظَهْر قَلْبٍ سَاهٍ ) . أقول : وفي العدة أيضاً عن الإمام علي ( عليه السلام ) : ( لا يَقْبَلُ اللهُ دُعَاءَ قَلْبٍ لاهٍ ) . أقول : وفي هذا المعنى روايات أخر ، والسر فيه عدم تحقق حقيقة الدعاء والمسألة في السهو واللهو . وفي دعوات الراوندي : في التوراة يقول الله عزَّ وجلَّ للعبد : ( إنَّكَ مَتَى ظلَلْتَ تَدْعُونِي عَلَى عَبْدٍ مِنْ عَبِيدِي مِنْ أجْلِ أنَّهُ ظَلَمَكَ فَلَكَ مِنْ عَبِيدِي مَنْ يَدعُو عَلَيكَ مِنْ أجْلِ أنَّكَ ظَلَمْتَه ، فإنْ شِئْتُ أجَبْتُكَ وأجَبْتُهُ فِيكَ ، وإنْ شِئْتُ أخَّرتُكُمَا إلى يَومِ القِيَامَةِ ) . أقول : وذلك أنَّ من سأل شيئاً لنفسه فقد رضي به ، ورضي بعين هذا الرضا بكل ما يماثله من جميع الجهات ، فإذا دعا على من ظلمه بالانتقام فقد دعا عليه لأجل ظلمه ، فهو راض بالانتقام من الظالم . وإذا كان هو نفسه ظالماً لغيره فقد دعا على نفسه بعين ما دعا لنفسه ، فإن رضي بالانتقام عن نفسه ولن يرضى أبداً عوقب بما يريده على غيره ، وإن لم يرض بذلك لم يتحقق منه الدعاء حقيقة . فقال تعالى : ( وَيَدْعُ الإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الإِنسَانُ عَجُولاً ) الإسراء : 11 . وفي عدة الداعي : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لأبي ذر : ( يَا أبَا ذَر ، ألا أعَلِّمُكَ كَلِمَات يَنْفَعُكَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِنَّ ) . قلتُ : بلى يا رسول الله . فقال ( صلى الله عليه وآله ) : ( احفظ اللهَ يَحفظكَ اللهُ ، احفظ اللهَ تَجِدْه أمَامَكَ ، تَعَرَّفْ إلى اللهِ في الرَّخَاء يَعْرِفُكَ فِي الشِّدَّة . وإذَا سَألْتَ فَاسْألِ الله ، وإذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ ، فَقَدْ جَرَى القَلَمُ بِمَا هُو كَائِنٌ إلَى يَومِ القِيَامَة ، وَلَو أنَّ الخَلْقَ كُلَّهُم جَهَدوا عَلَى أنْ يَنْفَعُوكَ بِمَا لَم يَكتُبْه اللهُ لَكَ مَا قَدَرُوا عَلَيهِ ) . أقول : قوله ( صلى الله عليه وآله ) : ( تَعَرَّفْ إلى اللهِ في الرَّخَاء يَعْرِفُكَ فِي الشِّدَّة ) يعني : ادعُ الله في الرخاء ولا تنسه حتى يستجيب دعائك في الشدة ولا ينساك ، وذلك أن من نسي ربه في الرخاء فقد أذعن باستقلال الأسباب في الرخاء ، ثم إذا دعا ربه في الشدة كان معنى عمله أنه يذعن بالربوبية في حال الشدة وعلى تقديرها . وليس تعالى على هذه الصفة ، بل هو رب في كل حال ، وعلى جميع التقادير ، فهو لم يدع ربه . وقد ورد هذا المعنى في بعض الروايات بلسان آخر ، ففي مكارم الأخلاق عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : ( مَنْ تَقَدَّمَ في الدُّعَاءِ أسْتُجِيبَ لَه إذَا نَزَلَ البَلاءُ ، وَقِيلَ : صَوتٌ مَعْرُوفٌ ، وَلمْ يُحْجَبْ عَنِ السَّمَاءِ ، ومَنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ فِي الدُّعَاء لَمْ يُسْتَجَبْ لَهُ إذَا نَزَلَ البَلاءُ ، وقَالَتِ المَلائِكُة : إنَّ ذَا الصَّوتِ لا نَعْرِفُه ) . وهو المستفاد من إطلاق قوله تعالى : ( نَسُواْ اللهَ فَنَسِيَهُمْ ) التوبة : 67 . ولا ينافي هذا ما ورد أن الدعاء لا يرد مع الانقطاع ، فإن مطلق الشدة غير الانقطاع التام . وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : ( وَإذَا سَألْتَ فأسْألِ اللهَ ، وَإذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ ) ، إرشاد إلى التعلق بالله في السؤال والاستعانة بحسب الحقيقة . فإن هذه الأسباب العادية التي بين أيدينا إنما سببيّتها محدودة على ما قدَّر الله لها من الحد ، لا على ما يتراءى من استقلالها في التأثير ، بل ليس لها إلا الطريقية والوساطة في الإيصال ، والأمر بيد الله تعالى . فإذن الواجب على العبد أن يتوجه في حوائجه إلى جناب العزة وباب الكبرياء ، ولا يركن إلى سبب بعد سبب . وإن كان أبى الله أن يُجري الأمور إلا بأسبابها ، وهذه دعوة إلى عدم الاعتماد على الأسباب إلا بالله ، الذي أفاض عليها السببية ، لا أنها هداية إلى إلغاء الأسباب والطلب من غير السبب ، فهو طمع فيما لا مطمع فيه . كيف والداعي يريد ما يسأله بالقلب ، ويسأل ما يريده باللسان ، ويستعين على ذلك بأركان وجوده ، وكل ذلك أسباب . واعتبر ذلك بالإنسان حيث يفعل ما يفعل بأدواته البدنية ، فيعطي ما يعطي بيده ، ويرى ما يرى ببصره ، ويسمع ما يسمع بإذنه ، فمن يسأل ربه بإلغاء الأسباب كان كمن سأل الإنسان أن يناوله شيئاً من غير يد ، أو ينظر إليه من غير عين ، أو يستمع من غير أذن . ومن ركن إلى سبب من دون الله سبحانه وتعالى كان كمن تعلق قلبه بيد الإنسان في إعطائه ، أو بعينه في نظرها ، أو بأذنه في سمعها ، وهو غافل معرض عن الإنسان الفاعل بذلك في الحقيقة ، فهو غافل مغفل . وليس ذلك تقييداً للقدرة الإلهية غير المتناهية ، ولا سلباً للاختيار الواجبي ، كما أن الانحصار الذي ذكرناه في الإنسان لا يوجب سلب القدرة والاختيار عنه ، لكون التحديد راجعا بالحقيقة إلى الفعل لا إلى الفاعل . إذ من الضروري أن الإنسان قادر على المناولة والرؤية والسمع ، لكن المناولة لا تكون إلا باليد ، والرؤية والسمع هما اللذان يكونان بالعين والأذن لا مطلقاً ، كذلك الواجب تعالى قادر على الإطلاق ، غير أن خصوصية الفعل يتوقف على توسط الأسباب . فزيد مثلاً وهو فعل لله هو الإنسان الذي ولده فلان وفلانة ، في زمان كذا ، ومكان كذا ، وعند وجود شرائط كذا ، وارتفاع موانع كذا ، لو تخلف واحد من هذه العلل والشرائط لم يكن هو هو . فهو في إيجاده يتوقف على تحقق جميعها ، والمتوقف هو الفعل دون الفاعل ، فافهم ذلك . وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : ( فَقَدْ جَرَى القَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إلَى يَومِ القِيَامَةِ ) ، تفريع على قوله ( صلى الله عليه وآله ) : ( وَإِذَا سَألْتَ فَاسْألِ اللهَ ) ، من قبيل تعقيب المعلول بالعلة ، فهو بيان علة قوله ( صلى الله عليه وآله ) : ( وَإِذَا سَألْتَ ) وسببه . والمعنى أن الحوادث مكتوبة مقدرة من عند الله تعالى لا تأثير لسبب من الأسباب فيها حقيقة ، فلا تسأل غيره تعالى ولا تستعن بغيره تعالى ، وأما هو تعالى : فسلطانه دائم ، وملكه ثابت ، ومشيته نافذة ، وكل يوم هو في شأن . ولذلك عقَّب الجملة بقوله ( صلى الله عليه وآله ) : ( وَلَو أنَّ الخَلْقَ كُلَّهُم جَهَدوا ) إلخ . ومن أخبار الدعاء ما ورد عنهم ( عليهم السلام ) مستفيضاً : ( إِنَّ الدُّعَاءَ مِنَ القَدَرِ ) . أقول : وفيه جواب ما استشكله اليهود وغيرهم على الدعاء : إن الحاجة المدعوّ لها إما أن تكون مقضية مقدرة أو لا ، وهي على الأول واجبة وعلى الثاني ممتنعة ، وعلى أي حال لا معني لتأثير الدعاء . والجواب : أن فرض تقدير وجود الشيء لا يوجب استغنائه عن أسباب وجوده ، والدعاء من أسباب وجود الشيء ، فمع الدعاء يتحقق سبب من أسباب الوجود ، فيتحقق المسبب عن سببه ، وهذا هو المراد بقولهم : ( إِنَّ الدُّعَاءَ مِنَ القَدَرِ ) . وفي هذا المعنى روايات أخر ، ففي البحار عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( لا يَرُدُّ القَضَاءَ إِلاَّ الدُّعَاءُ ) . وعن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : ( الدُّعَاءُ يَرُدُّ القَضَاءَ بَعْدَ مَا أبْرِمَ إبْرَاماً ) . وعن الإمام أبي الحسن موسى الكاظم ( عليه السلام ) : ( عَلَيكُم بِالدُّعَاءِ فَإِنَّ الدُّعَاءَ وَالطَّلَبَ إلى اللهِ عَزَّ وَجلَّ يَرُدُّ البَلاءُ ، وَقَدْ قَدَّرَ وقَضَى ، فَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ إِمْضَائِهِ ، فَإذا دُعِي اللهُ وَسُئِلَ صَرْفَ البَلاءِ صُرِفَا ) . وعن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : ( إِنَّ الدُّعَاءَ يَرُدُّ القَضَاءَ المُبْرَمَ وَقَدْ أُبْرِمَ إِبْرَاماً ، فَأكْثِرْ مِنَ الدُّعَاءِ ، فَإِنَّهُ مِفْتَاحُ كُلِّ رَحْمَةٍ ، وَنَجَاحُ كُلِّ حَاجَةٍ ، وَلا يُنَالُ مَا عِنْدَ اللهِ إِلاَّ بِالدُّعَاءِ ، فَإِنَّهُ لَيسَ مِنْ بَابٍ يَكثُرُ قَرْعُهُ إلاَّ أوْشَكَ أنْ يُفْتَحَ لِصَاحِبِهِ ) . أقول : وفيها إشارة إلى الإصرار ، وهو من محقِّقات الدعاء ، فإن كثرة الإتيان بالقصد يوجب صفائه ، وعن إسماعيل بن همام عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : ( دَعْوَةُ العَبْدِ سِرّاً دَعْوَةٌ وَاحِدَة تَعْدِلُ سَبْعِينَ دَعْوةٍ عَلانِيَةٍ ) ، أقول : وفيها إشارة إلى إخفاء الدعاء وإسراره ، فإنه أحفظ لإخلاص الطلب . وفي المكارم عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : ( لا يَزالُ الدُّعَاءُ مَحْجوباً حَتَّى يُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ) . وعنه ( عليه السلام ) أيضاً : ( مَنْ قَدَّمَ أرْبَعِينَ مِنَ المُؤمِنِينَ ثُمَّ دَعَا أستُجِيبَ لَهُ ) . وعنه ( عليه السلام ) أيضاً - وقد قال له رجل من أصحابه : أني لأجد آيتين في كتاب الله أطلبهما فلا أجدهما . فقال ( عليه السلام ) : ( وَمَا هُمَا ) ؟ قال الرجل : ( ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ) غافر : 60 ، فندعوه فلا نرى إجابة . فقال ( عليه السلام ) : ( أفَتَرَى اللهُ أخْلَفَ وَعْدَهُ ) ؟ ، قال : لا ، فقال ( عليه السلام ) : ( فَمَهْ ) ؟ ، قال : لا أدري . فقال ( عليه السلام ) : ( لَكِنِّي أخْبِرُكَ مَنْ أطَاعَ اللهَ فِيمَا أمَرَ بِهِ ثُمَّ دَعَاهُ مِنْ جِهَةِ الدُّعَاءِ أجَابَهُ ) . قال : وما جهة الدعاء ؟ ، فقال ( عليه السلام ) : ( تَبْدَأ فَتَحْمُدَ اللهَ وَتُمَجِّدَهُ ، وَتَذْكُرَ نِعَمِهِ عَلَيكَ فَتَشكُرَه ، ثُمَّ تُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ ، ثُمَّ تَذْكُر ذُنُوبَكَ فَتقُرُّ بِهَا ، ثُمَّ تَسْتَغْفِر مِنْهَا فَهَذِهِ جِهَة الدُّعَاء ) . ثم قال ( عليه السلام ) : ( وَمَا الآيَةُ الأخْرَى ) ؟ ، قال : ( وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ) سبأ : 39 ، وأراني أنفق ولا أرى خلفاً . فقال ( عليه السلام ) : ( أفَتَرَى اللهُ أخْلَفَ وَعْدَهُ ) ؟ ، قال : لا ، فقال ( عليه السلام ) : ( فَمَهْ ) ؟ ، قال : لا أدري . فقال ( عليهم السلام ) : ( لَو أنَّ أحَدَكُم اكتَسَبَ المَالَ مِنْ حِلِّه ، وأنْفَقَ فِي حَقِّه ، لَمْ يَنْفِقْ دِرْهَماً إلاَّ أخْلَفَ اللهُ عَلَيهِ ) . أقول : والوجه في هذه الأحاديث الواردة في آداب الدعاء ظاهرة ، فإنَّها تقرِّب العبد من حقيقة الدعاء والمسألة . وفي الدر المنثور عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ( إِنَّ اللهَ إذَا أرَادَ أنْ يَسْتَجِيبَ لِعَبدٍ أذِنَ لَهُ فِي الدُّعَاءِ ) . وعن ابن عمر أيضاً عنه ( صلى عليه وآله ) : ( مَنْ فَتَحَ لَهُ مِنْكُم بَابَ الدُّعَاءِ فُتِحَتْ لَهُ أبْوَابَ الرَّحْمَةِ ) . وفي رواية من فتح له في الدعاء منكم فتحت له أبواب الجنة . أقول : وهذه المعنى مروي من طرق أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) أيضاً : ( مَنْ أعْطَى الدُّعَاء أعْطِيَ الإِجَابَة ) . ومعناه واضح مما مَرَّ . وفي الدر المنثور أيضاً عن معاذ بن جبل ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ( لَو عَرَفْتُم اللهَ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ لِزَالَت لِدُعَائِكُم الجِبَالُ ) . أقول : وذلك أن الجهل بمقام الحق ، وسلطان الربوبية والركون إلى الأسباب يوجب الإذعان بحقيقة التأثير للأسباب ، وقصر المعلولات على عِلَلها المعهودة ، وأسبابها العادية . حتى أن الإنسان ربما زال عن الإذعان بحقيقة التأثير للأسْبَاب ، لكن يبقى الإذعان بتعين الطرق ووساطة الأسباب المتوسطة ، فإنا نرى أن الحركة والسير يوجب الاقتراب من المقصد . ثم إذا زال منا الاعتقاد بحقيقة تأثير السير في الاقتراب اعتقدنا بأن السير واسطة ، والله سبحانه وتعالى هو المؤثر هناك ، لكن يبقى الاعتقاد بتعين الوساطة ، وأنه لو لا السير لم يكن قرب ولا اقتراب . وبالجملة أن المسببات لا تتخلف عن أسبابها وإن لم يكن للأسباب إلا الوساطة دون التأثير ، وهذا هو الذي لا يصدقه العلم بمقام الله سبحانه ، فإنه لا يلائم السلطنة التامة الإلهية . وهذا التوهم هو الذي أوجب أن نعتقد استحالة تخلف المسببات عن أسبابها العادية ، كالثقل والانجذاب عن الجسم ، والقرب عن الحركة ، والشبع عن الأكل ، والري عن الشرب ، وهكذا . وقد مرَّ في البحث عن الإعجاز أن ناموس العلية والمعلولية ، وبعبارة أخرى توسط الأسباب بين الله سبحانه وبين مسبباتها حقّ لا مَنَاص عنه ، لكنه لا يوجب قصر الحوادث على أسبابها العادية ، بل البحث العقلي النظري ، والكتاب والسنة تثبت أصل التوسط وتبطل الانحصار ، نعم المحالات العقلية لا مطمع فيها . إذا عرفت هذا علمت : إن العلم بالله يوجب الإذعان بأن ما ليس بمحال ذاتي من كل ما تحيله العادة ، فإن الدعاء مستجاب فيه ، كما أن العمدة من معجزات الأنبياء راجعة إلى استجابة الدعوة . وفي تفسير العياشي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي ) البقرة : 186 : ( يَعْلَمُونَ أنِّي أقْدرُ أنْ أُعْطِيَهُم مَا يَسْألُونِي ) . المصدر: تفسير الميزان 2/30.