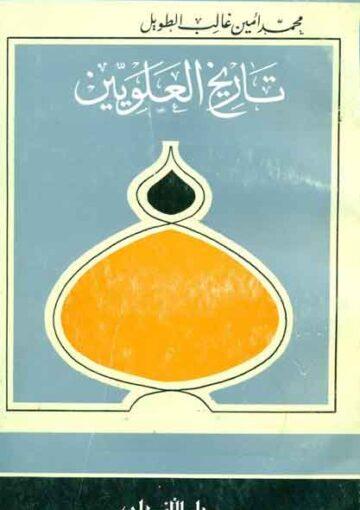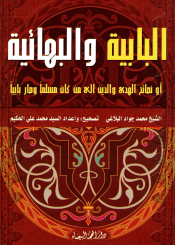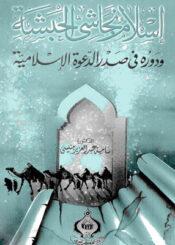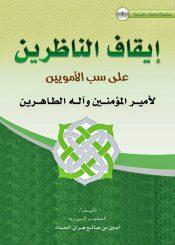تقرير المحتوى
قام الناقد، في تقريظ طويل نسبياً، بدراسة ادّعاءات المؤلّف واحدة تلو الأخرى، ورأى أنّ معظم أخطائه تعود إلى عدم رجوعه إلى المصادر الأصليّة، واعتماده على الآراء والعقائد الشفويّة الخاطئة بين الناس، وكذلك إلى جهله الدقيق بقواعد اللغة العربيّة بسبب خلفيّته غير العربيّة (نشأته في الإمبراطوريّة العثمانيّة)، فضلاً عن ميوله الصوفيّة.
كان محمد أمين غالب الطويل من العلويّين المهاجرين من كيليكية إلى اللاذقيّة. وبعد هجرته إلى أنطاكية ومنها إلى اللاذقيّة، انشغل بتعريب هذا الكتاب من التركيّة إلى العربيّة، واستعان في ذلك بأصدقائه العلويّين الملمّين باللغة العربيّة. وفي نقده وتقريظه للكتاب، تحدّث عبد الرحمن خير عن المؤلّف، ونسبه، ومكانته الاجتماعيّة والعلميّة والدينيّة، وعن أنّ محمد أمين غالب الطويل لم يتمكّن من حمل وثائقه العلميّة معه في الهجرة، كما ذكر لقاءه به في مجلس مناظرة حول هذا الكتاب، وجهود التحقيق والتصحيح فيه.
أبدى الناقد في مقدّمته معارضته لتفسير المؤلّف فروع العلويّين بأنّهم جماعة النصيريّة. كما خالفه في اعتقاده أنّ «العلويّين يرون سياسة عدم التوكّل وعدم السعي أفضل طريق لبلوغ أسمى غايات السعادة». ومن أبرز اعتراضاته أيضاً أنّه لا يرى العلويّين منفصلين عن الشيعة الإماميّة، بخلاف ما ذهب إليه المؤلّف.
قسّم المؤلّف المسلمين إلى ثلاثة أقسام: علويّين، وأمويّين، ومعتدلين، وهو تقسيم يقابل التقسيم المشهور إلى شيعة وسنّة. ورأى أنّ الدين كان من أعظم العوامل المؤثّرة في حياة البشر، وأنّ الأمويّين عدّوا لعن أمير المؤمنين عليّ(ع) من عقائدهم الدينيّة، ثم أضافوا لعن سبطي الرسول(ص)، الإمام الحسن(ع) والإمام الحسين(ع)، وبعض كبار العلويّين، وجعلوا ذلك شرطاً لقبول الصلاة. وفي مقابل هذا الفعل الشنيع، اعتبر العلويّون سبّ ولعن خصوم عليّ(ع) فريضة دينيّة يجب المواظبة عليها. كما عدّ المؤلّف الإمام بعد السيّد السجّاد(ع) عند العلويّين زيد الشهيد، وجعل شرعيّة الإمامة قائمة على البيعة، وهو ما ردّه الناقد مؤكّداً أنّ الإمامة ثابتة للأئمّة الاثني عشر الذين نصّ عليهم النبيّ الأكرم(ص). وذكر الناقد أنّ الإمام الصادق(ع) أوصى بالإمامة لابنه إسماعيل، فلمّا توفّي قبل أبيه أوصى بالإمامة لابنه الثاني الإمام الكاظم(ع).
وفي باب أنساب العلويّين، قسّم المؤلّف العرب إلى بائدة وعاربة ومستعربة. وذكر أبا سفيان وأبا جهل أوّل من جاهر بعداوة النبيّ(ص). كما روى قصّة الغدير وبحث فيها. ومن جملة ما نسبه المؤلّف إلى العلويّين اعتقاد عجيب بأنّ النبيّ(ص) لم يكن يكلّف الناس جميعاً على حدّ سواء بالواجبات. ونسب تشيّع علويّي الشام إلى تعاليم أبي ذر الغفاري، والمقداد بن الأسود الكندي، وغيرهم من الأنصار الذين استوطنوا جبل الحلو قرب حمص. واعتبر أركان الشيعة سلمان، والمقداد، وبلال، وعمّار، وهو ما عدّه الناقد خطأ، إذ الركن الثالث هو أبو ذر لا بلال.
وأطلق المؤلّف على أبي حنيفة لقب "الإمام الأعظم"، متأثّراً ببيئته العثمانيّة التركيّة. كما رأى أنّ الشيعة يستندون في أحاديثهم إلى أم سلمة، والسنّة إلى عائشة. وذهب إلى أنّ علم الباطن ليس مقصوراً على الإسماعيليّة، بل هو خاصّ بالعلويّين.
غلبت على المؤلّف نزعات صوفيّة، وكأنّه أراد أن يقدّم الصوفيّة بوصفهم العلويّين الحقيقيّين. وقد نسب انتصار الفاطميّين في مصر إلى ذكاء ناتج عن "إصابة أشعّة الشمس لأدمغتهم"، كما أثنى على محيي الدين ابن عربي. وذكر افتراق العلويّين إلى عشائر وعماير وبطون، وأورد أسماءهم وتقسيماتهم، واعتبر هذه الانقسامات حكمة لتسهيل الانتقام من الظالمين للعلويّين. كما ذكر ما أصاب العلويّين من المصائب على يد الصليبيّين، وإنقاذهم بمساعدة صلاح الدين الأيوبي، ثم تضييق الأكراد عليهم. وأشار إلى حصول العلويّين على حقوقهم السياسيّة في سبتمبر 922م، وتولّيهم مناصب القضاء وقاضي القضاة. كما فسّر فقر العلويّين بتبعيّتهم للأئمّة وكبارهم الدينيّين مثل أبي ذر وسلمان وغيرهما.
وتحدّث عن الخلافات التاريخيّة بين الشيعة والسنّة بوصفها عاملاً في إضعاف العلويّين والأمّة الإسلاميّة جمعاء، ورأى أنّ الحلّ يكمن في التفاهم مع الصراحة في الطرح. وفي الكتاب عقائد ذات طابع أخباري، مثل القول بأنّ العلويّ لا يستنبط الأحكام الشرعيّة من قواعد الصرف والنحو، بل إنّ استنباط الأحكام خاصّ بأهل البيت(ع). وختاماً، دعا المؤلّف إلى المساواة بين الشيعة والسنّة، وإلى تغليب الروابط القوميّة على الروابط العقائديّة.